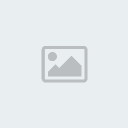Lover Palestine
Admin


الجنس :  عدد المساهمات : 203 عدد المساهمات : 203
نقاط : 6101
تاريخ التسجيل : 19/01/2010
العمر : 30
الموقع : www.as7atop.com
العمل/الترفيه : الصيد
المزاج : رايق
 |  موضوع: احمد باشا الجزار موضوع: احمد باشا الجزار  الجمعة ديسمبر 24, 2010 4:49 am الجمعة ديسمبر 24, 2010 4:49 am | |
|
مقدمة:
في هذا البحث البسيط بعنوان احمد باشا الجزار أتعرض لهذه الشخصية قوية وأيضا كان للجزار دور بارز في تطور مدينته من خلال المسجد الذي بناه وحمل اسمه، إضافةً إلى خمسة أو ستة مساجد أخرى كانت موجودة من قبل، كما ذكر براون وجود حمامات وسوقين وقصراً وخزانين للمياه والخانات التي تُخزَّن بها البضائع وإنشاء مكان خاص لإقامة التجار والمسافرين.
هوايتي:
فأنا كإنسان اهوي القراءة واستخدام الانترنت والحاسوب لأنني أجد نفسي في ذلك ولأنني باستطاعتي تجميع جهاز كمبيوتر بالكامل .
رأي لهذا البحث بأنه جيد ولكن الشخصيات التاريخية تحتاج إلي وقت كبير لان كل شخصيه تاريخيه مرت بمواقف وأمور كبيرة وعظيمه ولو أراد الواحد منا أن يذكرها فانه يحتاج إلي وقت اكبر بكثير.
إهداء
إلي والدي ووالدتي,,
إلي أساتذتي الكرام الذين يسطرون أجمل اللحظات لكي يسمو بنا إلي مراتب التفوق والنجاح,,
إلي كل من يساعدني لكي انجح في حياتي,,
إلي شهداء فلسطين رحمهم الله,,
إلي الأسري القابعين في سجون الاحتلال,,
إلي من اعشقها وأهوي ترابها " فلسطين",,
,,,,,,,
أحمد باشا الجزار
تولى أحمد باشا الجزار ولاية عكا أولاً ثُمَّ ضمَّ إليه ولاية الشام ثانياً خلال الفترة من 1775-1804م، وهو من الشخصيات التي يصعُب على الباحث تجاهل أهميتها نظراً للدور البارز الذي اضطلع به خلال فترة حكمه الطويلة والتي دامت خمساً وعشرين عاماً.
ولمَّا كنتُ قد قمت في عام 2000م، بإعداد رسالة الدكتوراه عن تلك الشخصية البارزة وأسميتها وقتذاك: " أحمد باشا الجزار: إدارته وعلاقاته السياسية والاقتصادية بالقوى الإقليمية والدولية"، فلم أتطرَّق حينئذ للحياة الثقافية في عهده؛ لذا فقد وجدتُ لزاماً علىَّ التطرُّق لتلك الجزئية في بحثٍ مستقل تحت مُسمى: "الحياة الثقافية في فلسطين ولبنان في عهد أحمد باشا الجزار من 1775-1804م".
وإذا كان أحمد باشا الجزار قد حكم بلاد الشام بالحديد والنار، أو إن جاز التعبير بقبضةٍ حديدية، عانى منها الأهلون الأمرين، كما كان الوضع الاقتصادي في عهده صعباً نتيجةً لسياسة الاحتكار الاقتصادي الذي فرضه على البلاد؛ فإن الحياة الثقافية كذلك شابها الغموض ولم تزدهر في عهده ازدهاراً كافياً.
ونظراً لأهمية المناطق التي حكمها الجزار من الناحية الدينية، خاصةً فلسطين فقد كثُر بها العلماء الذين كان لهم دورُ بارز في الحياة الثقافية، ولم يكن بمقدور الجزار إيقاف مسيرتهم التعليمية والثقافية، وذلك لقوة مكانتهم الاجتماعية بين السكان، ولقدرتهم على الشكوى منه لدى الباب العالي في الآستانة.
وكانً لتنوع المذاهب الدينية في المناطق التي خضعت لحكم الجزار المباشر وغير المباشر، أثرٌ مهم فقد كان من الصعب أن تُثمر عن أيَّة نتيجة تخدم الحياة الثقافية، خاصةً في لبنان الذي ذاق الأمرين نتيجةً لسياسات أمرائه، الذين لم يكن لهم من همٍ سِوى الحصول على منصب الإمارة من الجزار بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب مستوى حياة السكان الاقتصادية والثقافية، ولمَّا كان الجزار يخشى ما يخشاه من اتحاد الكلمة بين سكان لبنان بجميع طوائفه، فقد عمد دوماً لزرع بذور الشقاق بينهم، وأضرم نار الفتنة بين عددٍ من زعمائه، خاصة بين أمير جبل لبنان الأمير يوسف الشهابي وبني صَعبْ المتاولة حكام بلاد بشارة والشقيف، وتمكَّن الشهابيون من تحقيق بعض الانتصارات، مما أدّى إلى عجز المتاولة عن حفظ استقلالهم.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للروايات التاريخية الخاصة بموضوع البحث على قلتها. وقد اعتمدت هذه الدراسة أساساً على عددٍ من المصادر التي عاصرت الأحداث مثل:
1ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لمحمد بن خليل المُرادي.
2ـ تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري لحسن بن عبد اللطيف الحسيني.
3ـ رسائل القنصل الفرنسي في عكا.
إضافةً لكتب الرحالّة الأوربيين الذين زاروا المنطقة خلال فترة حكم الجزار وأمدونا بمعلوماتٍ وافية ومُفصلة عن الحياة الاجتماعية لتلك المنطقة، تلك المعلومات التي استفادت منها الدول الأوروبية الاستعمارية فيما بعد في غزو بلادنا عسكرياً وثقافياً، الأمر الذي انعكس على تاريخ بلاد المشرق في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين.
المظاهر الثقافية في فلسطين قُبيل الجزار:
حظيت الكتابة التاريخية في بلاد الشام في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، باهتمام المؤرخين لسببين، أولهما: تقليدهم للمؤرخين السابقين، وثانيهما: كثرة الأحداث السياسية وما تميز به ذلك القرن من طرق صوفية، وقد تناول المؤرخون في هذا القرن الكتابة التاريخية بأشكالها المتنوعة، وعكس تدهور الكتابة التاريخية وقتذاك، تدهوراً عاماً في الحياة العلمية والفكرية، فالحكم العثماني لهذه المنطقة كان يقوم على مبدأ بقاء الأوضاع فيها بشكلٍ عام، على ما كانت عليه قبل استيلائهم عليه.
وقد حظيت فلسطين، شأنها شأن بقية أقطار بلاد الشام الأخرى، بمصادر هامة لدراسة النواحي الثقافية منذ مطلع الحكم العثماني، وتضم هذه المصادر بالإضافة إلى كتب التراجم والرحلات والعلوم الدينية كالفتاوى وغيرها كوثائق المحاكم الشرعية.
ولمَّا كانت الأوضاع السياسية في بلاد الشام خلال العهد العثماني قد تأثرت سلباً أم إيجاباً كثيراً بالأوضاع السائدة في الآستانة وفي كافة أنحاء الدولة العثمانية، نجد على النقيض من ذلك أن الحياة الاجتماعية والثقافية تابعت مسيرتها التقليدية بمعزلٍ عن أية تطورات أو تأثيرات هامة في الآستانة، وبقيت الحياة الثقافية بشكلٍ خاص، إحدى الثوابت الرئيسية التي تُعبّر عن هوية الأمة العربية ـ الإسلامية، وهذا ما يُدلّل على غياب أية سياسة ثقافية إسلامية في أداء الدولة.
وكان للمدن الفلسطينية دورٌ مهم عبر التاريخ في كافة النواحي، ومنها الناحيتين الثقافية والدينية، وكذلك تنوّع تركيبها السكاني حسب وظائفها، فالقدس على وجه الخصوص لكونها تضم أماكن دينية مقدسة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، استقطبت فعاليات ثقافية ودينية عدّة، محلية وعربية وإسلامية وأجنبية، أما المدن الساحلية، فعملت على جذب الجاليات التجارية المحلية والأجنبية، نظراً لاتصالها بالطرق التجارية الرئيسية في البحر المتوسط التي أتاحت لها المُتاجرة مع موانئ بلاد الشام ومصر وآسيا الصغرى وأوروبا.
واستفادت بعض المدن الفلسطينية كذلك من وقوعها على الطريق البرية التي تصل بلاد الشام بمصر، كما أن قافلة الحج الشامي التي كانت تضم ما يقرب من عشرين ألف حاج سنوياً، كانت تلجأ في طريق عودتها إلى تحويل طريقها عبر مدينة غزة لتحاشي هجمات القبائل البدوية عليها، وقد عُرف هذا الطريق "بالطريق الغزاوي"
وساهم علماء فلسطين بقدرٍ وافر في النشاط الثقافي الديني بين مطلع القرن السادس عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين، وكُتب التراجم الدمشقية مليئة بأخبار هؤلاء العلماء وتنقلاتهم ومنجزاتهم، وما اشتهروا به من عِلمٍ، وما أسهموا به في تطوير الثقافة الدينية بعامة، والسبب الذي يدعونا لاعتماد كُتب التراجم الدمشقية هو أن أصحابها خبروا شؤون فلسطين الثقافية، إما لأنهم من أصول فلسطينية، قريبة أو بعيدة مثل نجم الدين الغزي والحسن البوريني، أو قاموا بزيارتها للتبرُّك أو الدراسة والتدريس، أو توقفوا فيها أثناء سفرهم إلى الحجاز أو مصر كالشيخ عبد الغني النابلسي، أو أنهم اعتمدوا على مراسلين فيها لتغطية أخبار علمائها، كما فعل مفتي دمشق "محمد خليل المرادي" الذي قام بتأليف كتاب "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" (الهجري)، والذي طلب من حسن بن عبد اللطيف الحسيني المقدسي أن يوافيه بأخبار علماء بيت المقدس، وفي ذلك يقول حسن بن عبد اللطيف الحسيني: "فامتثالاً لأمره المُطاع، حررت هذه الرسالة..."
ومما يجدُر ذكره، أن نصف أعلام القدس كانوا من العلماء الأفندية، بينما نصفهم الآخر كان من رجال الإدارة والتُجار والمثقفين الجُدد، من أدباء وغير ذلك، أما جبل نابلس الذي تمتع بقدرٍ أكبر من الحكم الذاتي حتى أواسط القرن التاسع عشر، فكان معظم أعلامه من البكوات والأغوات الذين شغلوا مناصب الحكم والإدارة.
وقد حظي لواء القدس والخليل بحصةِ الأسد بالنسبة لأعلام فلسطين، وتحتل منطقة بئر السبع المكان الثاني، كما كان لمنطقة نابلس وجنين تمثيلاً يتلاءم تقريباً مع حجمها السكاني والسياسي، أما المنطقة الوحيدة التي جاء تمثيلها في الأعلام ضعيفاً، فهي شمال فلسطين الذي يضم حيفا وعكا والجليل بمدنه صفد وطبرية والناصرة، ويعود السبب الأول لضآلة عدد أعلام حيفا والجليل، إلى النقص في المحفوظات والمراجع التي تُشكّل المادة الخام لكتابة التاريخ، فقد ضاعت سجلات المحاكم الشرعية في صفد وعكا وطبرية والناصرة، بينما حُفِظت في القدس ونابلس ويافا، كما أن حرب فلسطين عام 1948م، وتهجير السكان العرب من معظم تلك المدن ساهما في ضياع أوراق العائلات وتاريخها.
ولا يُعتبر افتقاد المحفوظات والمصادر العامل الوحيد والأساسي لهذا التمثيل الضعيف، إذا استثنينا مدينة صفد التي لم يُعثر على معلوماتٍ لترجمة أي واحدٍ من أعلامها، ففي الجليل، المنطقة الجبلية المشابهة لجبال القدس ونابلس لم تتمكن عائلات مشايخ الريف من المحافظة على مكانتها ونفوذها، فقد قوَّض الشيخ ظاهر العمر تلك العائلات، ولم يسمح حكام عكا خاصة أحمد باشا الجزار بتوسيع هامش الحكم الذاتي للسكان في هذه المنطقة.
وكانت منطقة القدس - بسبب مركزها الديني والعلمي المميز- نقطة تجمع والتقاء لعددٍ كبير من العلماء والمدرسين وطلاب العلم، كما كان بعض المدرسين يقوم بوظائف علمية أخرى إلى جانب وظيفته كالعمل في القضاء والقيام بالخطابة في أحد المساجد، والمواد التي يتم تدريسها في دور التعليم المقدسية لم تكن تخرج عن العلوم الشرعية والعلوم اللسانية، ويبدو أن المدارس المقدسية كانت آنذاك مُقسمة حسب المذاهب السنية، فكانت هنالك المدارس الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية.
ويذكر البعض أنه يُلاحظ من خلال كثرة المعاهد العلمية من مساجد ومدارس ومكتبات، أن عدداً كبيراً من طلاب العلم كانوا يفدون إلى القدس للدراسة في معاهده المختلفة، إضافةً إلى طلاب العلم من أبناء منطقة القدس ذاتها، وقد أدّت المدارس في هذه الفترة دوراً بارزاً إلى جانب المسجد الأقصى الذي كان يعتبر قطب الرحى للحركة العلمية في القدس، وجميع المدارس متعلقة به ودائرة في فلكه؛ نظراً لمكانته السامية لدى جميع المسلمين.
وبجانب المدارس، كانت الزوايا إحدى مراكز الحياة العلمية في القدس خلال هذه الفترة، حيث يؤمها المتصوفة لغرض العبادة وتدريس العلوم المختلفة، ورواد هذه الزوايا لم يقتصروا على سكان منطقة القدس، بل تعداه إلى كثير من شيوخ المتصوفة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وكان للمكتبات في القدس دورُ بارز في الحياة العلمية والثقافية، فقد حفظت سجلات محاكم القدس الشرعية إحصاء بتركات بعض علماء المدينة في القرن الثامن عشر الميلادي، وتعتبر مكتبة المسجد الأقصى من أهم دور الكتب في القدس، حيث كان هذا المسجد مركزاً للحياة العلمية والفكرية ومدرسة لتدريس مختلف العلوم، وتحتوي مكتبة المسجد على عددٍ كبير من الكتب في شتى الفنون كاللغة العربية والدين والتاريخ والحساب والميقات، وكانت خزائن الكتب موزعة بين المسجد الأقصى والصخرة المشرفة، ومن الكتب التي يحويها غير القرآن الكريم، كتاب "نشق الأزهار في عجائب الأقطار" لمحمد بن أياس الحنفي.
ومن أشهر مكتبات القدس قُبيل عهد أحمد باشا الجزار، نجد مكتبة الشيخ محمد الخليلي، الذي كان يُعد من كبار علماء وأعيان القدس في القرن الثامن عشر، وكوَّن لنفسه مكتبة ضخمة حوت حوالي سبعة آلاف كتاب.
ومما يؤسف له أن علماء وأعلام فلسطين لم يكونوا ذا شهرة واسعة في الخارج، وكانوا مجرد صوفيين محليين اشتهروا بكراماتهم واعتقاد العامة بهم، ولم يسهموا في مجال العلوم الدينية وتدريسهم في المدارس وقيامهم بوظائف دينية مهمة، فلم يصلوا إلى رتبة أعيان العلماء؛ لذا أهملهم الرحّالة المسلمون في كتاباتهم إلاَّ فيما ندر، وقد اعتمد البعض منهم على نقل أخبار علماء فلسطين في كتبهم عن طريق الغير، مثل الأخذ من الأفواه شفاهةً وبالكتابة إلى من في تلك البلاد التي لم يرها، وفي ذلك يقول محمد خليل المرادي: "أنه اجتمع لديَّ جملةً من الرحلات والإثبات والتراجم مع كثرة التنقير والتفحص الكثير والأخذ من الأفواه شفاهاً وبالمكاتبات إلى البلدان التي كنت لست أراها"، وقد اطّلع المرادي على ما كتبه الرحّالة المسلمون مثل عبد الغني النابلسي عن علماء فلسطين التي لم ترقَ علمياً إلى مستوى الأخذ بها.
والحقيقة أن فلسطين في القرن الثامن عشر لم تكن خالية تماماً من العلماء، فنجد منهم الشيخ عبد القادر الحفناوي الذي تلقى الشيخ ظاهر العمر العلم على يديه في صباه، فعلّمه القرآن الكريم وبعض الآداب وكذلك الكتابة، كما انتعشت اللغة العربية في عهد الشيخ ظاهر العمر، ويدل على ذلك الكمّ الهائل من التراث الشعبي والشعر الشعبي الذي يمدحه ويمدح نظام حكمه وكذلك أبنائه.
ومما يدل على انتشار الثقافة والوعي الأخلاقي في فلسطين قبل عهد الجزار، ما قام به ظاهر العمر من محاربة البدع المنتشرة في صفوف العامة، وعمله جاهداً للقضاء على الخزعبلات الموجودة في عكا، وهذا يؤكد على سياسة الحزم والشدة التي اتبعها من أجل تطبيق مبادئه الإصلاحية خاصة في مجال المحافظة على القيم الأخلاقية والقضاء على البدع التي كانت منتشرة آنذاك في بلاد المشرق، وتؤثر على الحياة الثقافية بين سكانه.
ومن يدقق النظر في كتب التراجم التي تمَّ تأليفها في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، يُلاحظ سلسلة طويلة ومتصلة الحلقات من العلماء الذين تلقوا تعليمهم بالأزهر الشريف أو دمشق أو القدس أو غيرها من المراكز الثقافية البارزة في العهد العثماني، كما نجد أن كثيراً من أهل الشام ومنها فلسطين من علماء الأزهر، حيث عِمل بعضهم بالتدريس والإفتاء بالجامع الأزهر، بعد أن أُجيزوا من علمائه ووُصفوا بأنهم من أعيان أهل الإفادة والتدريس بالجامع الأزهر.
وكان من بين علماء القدس الذين درسوا في الأزهر الشريف الشيخ محمد الخليلي- الذي سبق ذكره، وفي ذلك يقول حسن بن عبد اللطيف الحسيني: "... وتوجه لمصر الأمصار (أي الشيخ محمد الخليلي)، فطلب وجدَّ، وأخذ عن علمائها الكرام الأبرار، ومنحه الله بالجامع الأزهر، والمقام الأنور الاجتماع بالخضر عليه السلام ودعا له بمزيد العلم والأنعام، فزاد به الحال، وترقى أعلى مراتب الرجال".
وإضافة للدراسة في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، فثمة من درس من أهل فلسطين في دمشق كذلك، منهم السيد بدر الدين بن محمد الذي توجه إلى دمشق سنة 1164هـ/1750م، وتلقى العلم من علمائها منهم الشيخ حامد أفندي العمادي المفتي وقتذاك، الذي أجازه بسائر مروياته، وكتب له بها أبياتاً شعرية، منها:
يا خطيبـاً وفاضـلاً وإمامـاً عزّ أنْ يضاهيك مُفرداً وجماعـة
إذ حويتَ الكمالَ في كل فضلٍ مفـرداً في الأنـام وابـنَ جماعة
مذ بدا وصفُك الرفيـع بديعـاً يرتجي العفو ليس يخشى الإضاعة
يتضح مما سبق ذكره، أن الحياة العلمية والثقافية في فلسطين، كانت متأثرة بالنواحي الدينية وتدور في فلكها، نظراً لاعتناق غالبية سكان فلسطين للدين الإسلامي، الدين الرسمي للدولة العثمانية صاحبة السلطة الفعلية في تلك البلاد.
أما في لبنان، فالظروف مختلفة كثيراً عما كان عليه الحال في فلسطين، نظراً لتباين الأديان واختلاف الملل والنحل فيه، فشماله مسلم سُنّي، ووسطه مزيج من الأديان تغلب عليه المسيحية بكافة مذاهبها، وجبل لبنان تقطنه أغلبية درزية، بينما يسيطر المسلمون الشيعة على جنوبه فيما سُميَ بجبل عامل.
كانت مدينة طرابلس أشهر مدن شمال لبنان، وهي مدينة يغلب عليها العنصر الإسلامي السُنّي؛ لذا كان للوظائف الدينية بها أهمية خاصة، سواء من أهلها أم من العلماء الذين وفِدوا عليها، فالعثمانيون بعد استيلائهم على بلاد الشام ومنها لبنان، أعادوا تنظيم الجهاز القضائي المملوكي، فأُعطيت المنزلة الأولى للقاضي الحنفي ـ مذهب الدولة الرسمي ـ ولم يكن هذا يعني إلغاء بقية المذاهب، فقد كان يُطلب من القضاة في المحاكم أن يعرضوا أحكامهم على القاضي الحنفي في المحكمة لإجازة مثل تلك الأحكام.
واشتهر من علماء طرابلس، قاضيها عبد الكريم أفندي الكنغري من قصبة بالقرب من أنقرة، وألف نحو تسعين كتاباً، وقد قابله يحيى بن أبي الصفا ابن محاسن خلال رحلته إلى طرابلس وقال عنه: "ثم تشرفنا بقاضي البلدة مفخر الموالي العظام والأفاضل الفخام عبد الكريم أفندي الكنغري من قصبة بالقرب من أنكورية،... وهو في الجملة والتفصيل مظهر من المظاهر قد فاق على الأوائل والأواخر، كبير في السن، يحب الدنيا الدنية، ممتحن تمر به غالب الأوقات وهو في الأمراض..." ، كما اشتهر أيضاً من علماء طرابلس، الشيخ العلاَّمة عبد الكريم ابن الشيخ مصطفى الشافعي الحموي، ونقيب الأشراف السيد حسن ابن السيد يحيى الطرابلسي .. الخ.
وفي منطقة جبل عامل بالجنوب اللبناني، فقد كانت السيادة للشيعة (المتاولة) المسلمين، المضطهدين من جانب ولاة الدولة العثمانية، ورغم هذا الاضطهاد فإن منطقة جبل عامل أخرجت عدداً وافراً من أهل العلم والفضل وذوي الثقافة العالية لا يتناسب مع ضيق رقعتها وقلة ساكنيها، ويؤكد محمد جابر آل صفا(25): "... أن القطر العاملي كان في طليعة الأقطار السورية من حيث الشهرة العلمية، وقد أحرز في هذا الشأن شأواً بعيداً لا يدانيه قطر آخر، لا سيما في القرون الأخيرة حيث كان مثابة للرحلة العلمية من الآفاق، ومركزاً هاماً من مراكز التدريس الكبرى، يؤمه الطلاب من كل فوجٍ وصوب، ولم ينقطع فيه مدد العلم، ولا خبا نوره إلاَّ في فتراتٍ قصيرة كانت تعقب الحروب والفتن التي يرافقها التدمير والخراب وإقفال المدارس وتعطيل معاهد التدريس".
ومن أشهر المدارس الشيعية التي وُجدت في جبل عامل، مدرسة شقراء التي أسسها العلامة السيد أبو الحسن موسى بن حيدر الحسيني العاملي المتوفى سنة 1195هـ، وكانت تضم أربعمائة طالب، وقد تسنى لهذه المدرسة أن تزدهر وتتقدم في العلوم بسبب ما توفر لها من مداخيل أمّنت لها الاستقرار والسير الحثيث نحو الاكتفاء، والاستغناء عن طلب العون، وقد ضعُفت هذه المدرسة بعد غياب مؤسسها بسبب سوء الإدارة، وضعف النشاط العلمي، ولكن حفيد السيد أبي الحسن السيد علي الأمين أعاد لها مركزها العلمي ومستواها اللائق بها، وكان العلم والأدب في جبل عامل في هذا العهد قد بلغ حده الأقصى، وزهت المنطقة بالعلماء والأدباء وأهل الفن والتأليف، غير أن الأقدار شاءت أن يقف سيرها ويخبو نورها وتتعطل حركتها وتذوي نضارتها بسبب الحروب والفتن بين زعماء جبل عامل وولاة الدولة العثمانية(26).
وكان للدين أثره الفعّال في المجتمع العاملي؛ إذ راح يطبعه بطابع العقيدة المتأتية من التيار الفكري المتأثر بطلاب العلم الوافدين من العراق وإيران، وقامت محاولات عديدة ترمي إلى تحديد زمن النشأة الأدبية في جبل عامل، ولكن هذه المحاولات أغفلت تحديد الأزمنة التي حضنت هذه النشأة، كما أنها لم تُلمَّح إلى أسباب قيامها، أو تعمد إلى تسميتها وتبيان خصائصها المميّزة ليصحّ تسميتها بالنشأة(27).
وقد تميز القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، في إسهام رجال الحكم في بلاد عامل بنشر المعارف، واحتضان المدارس، وإعانة القائمين عليها، والتردّد إليها، ومن الدلائل التي تشير إلى تأثر الجو الأدبي العاملي بالأجواء السياسية وحكامها، أن الشاعر إبراهيم الحاريصي (1183هـ/1769م) قصر شعره على مدح السياسيين، وفي مقدمته ناصيف بك النصار، الذي كان يحكم المقاطعات الجنوبية من جبل عامل، ومركز حكمه قلعة هونين، وقد توفي سنة 1195هـ/1781م، في معركة يارون التي شنها أحمد باشا الجزار ضد جبل عامل، وغيره من الشعراء الذين حذوا حذوه، ونالوا الحظوة لدى رجال الحكم وأهل السياسة(28).
ولكثرة ما غذّى زعماء المتاولة شعراءهم بروح العداء والعصبية، أصبح الشعر يحمل طابع السرد والقصّ والتفاخر بالآباء والأجداد، والاعتزاز بالعنصرية والمذهب، فقد تضمنت شيئاً من تاريخ العامليين بلغةٍ شعبية لا تختلف كثيراً عن اللغة الدارجة اليوم، لكنها تحمل الكثير من أثر اللغة الفصحى مع كلماتٍ عامية تبدو مجهولة المعنى(29).
كما اهتم العامليون في الفقه والتفسير وأصول الأحكام الشرعية، فقد اهتموا بسير الرجال البارزة في الدين والعلم، وجعلوا لها اهتماماً مميزاً ونظرة مفصلة ومكانة جديرة بالإجلال، كذلك اهتموا بسرد الأحداث التاريخية، ومن أشهر المؤلفات في هذا الصدد، نجد كتاب "تاريخ جبل عامل" للشيخ العنقاني، وهو تاريخ مختصر يتناول الأحداث التي سجلتها حوادث جبل عامل منذ سنة (1043هـ/1633م) حتى سنة (1152هـ/1736م)، وكذلك "جبل عامل في قرن" لحيدر رضا الركيني، الذي يؤرخ للأحداث من سنة (1164هـ/1750م) وينتهي سنة (1247هـ/1821م)(30).
لم تكن في جبل عامل مكتبات عمومية، وكل ما وُجِدَ فيها مكتبات خاصة بأهلها، والمشكلات التي واجهت هذه المكتبات إنها كانت محفوظة ما دام صاحبها حياً؛ فإذا توفي أما أن تذهب أيادي سبا بيد اللصوص والمستعرين والمشترين بثمنٍ بخس والمستوهبين، أو تتلفها الأرضة، وتراكم التراب والغبار وسقوط ماء السقوف عليها ودخان النار وتعاور الأيدي الوحشية التي تُمسك الكتاب كأنها تمسك حديداً أو حجراً صلداً فلا تلبث أن تقلع جلده وتبدد أوراقه ولا يوجد من يُصلحه، ومن أشهر المكتبات المعروفة التي كانت موجودة آنذاك، نجد مكتبة الشيخ عبد الله نعمة في جبع، التي كانت حافلة بنفائس المخطوطات، لكنها تفرقت أيديٍ سبا وضاعت، ومكتبة آل الحُر في جبع أيضاً، ولم يبقَ فيها إلاَّ القليل وتوزعتها أيدي الورثة وغيرهم، ومكتبة آل السُبيتي في كفرة، التي لم تكن أحسن حظاً من غيرها، ومكتبة الشيخ أحمد الرضا في النبطية التحتا، وهي مُرتّبة ولها فهرست وفيها كتب مخطوطة نادرة، ومكتبة الشيخ سليمان ظاهر في النبطية، وتحوي عدداً كبيراً من نفائس الكتب وآثار جبل عامل(31).
أما وسط لبنان، خاصةً جبل لبنان ذو الأغلبية المسيحية، فالجدير بالملاحظة، أنه في هذه الفترة وما يليها، برز عدد من الكتّاب المسيحيين الذين أسهموا في كتابة التاريخ المحلي لبلاد الشام، وقد ازدهرت الحركة التاريخية في هذه المنطقة في السنوات الثلاثمائة الأخيرة وذلك عن بقية الولايات العربية، ويعود هذا الازدهار لعدة أسباب منها:
أولاً: الوضع السياسي الخاص الذي تمتع به جبل لبنان.
ثانياً: ظهور طبقة من المثقفين أتقنت اللغة العربية، بالإضافة إلى اهتماماتها بشؤون العصر الحديث في أوروبا.
ثالثاً: وجود مادة تاريخية موحدة، سواء كانت سياسية أم دينية، حيث دفعت هذه المادة الكتّاب إلى توضيحها والدفاع عنها(32).
ووصل الأمر بالبعض، إلى اعتبار القرن الثامن عشر الميلادي، هو عهد النهضة الأدبية في الوسط العربي المسيحي، فقد كانت غالبية المؤرخين اللبنانيين من الكهنة الذين تلقوا تعليمهم وثقافتهم في المدارس اللاهوتية في روما؛ لذا فقد دافعوا عن المؤسسات التي انتموا إليها، وحاولوا إثبات وجودهم واستقلالهم السياسي في محيط أغلبية من المسلمين، وخير من مثَّل هذا الاتجاه الديني السياسي هو البطريرك الماروني اسطفان الدويهي المتوفى عام 1116هـ/1704م، في كتابه "تاريخ الأزمنة"، حيث مهد فيه للمؤرخين المسيحيين الموارنة اللاحقين، الطريق للبحث التاريخي الحديث(33).
ونتيجةً للتطورات السياسية التي مرَّ بها جبل لبنان في القرن السابع عشر والثامن عشر ظهرت طبقة جديدة من المثقفين، انخرطت في البناء السياسي الجديد، وكانت لديها القدرة على كتابة تاريخها، وأغلب هؤلاء ينتسبون لعائلات متعلمة وعلمانيين تثقفوا في المدارس التبشيرية وفي الأديرة، والأهم من ذلك أنهم تعلموا اللغة العربية على يد علماء مسلمين، وقد أخذت هذه الفئة تركز على تدوين تاريخ الأسر الإقطاعية في جبل لبنان، أمثال طنوس الشدياق الذي دوَّن كتاب "تاريخ الأعيان في جبل لبنان"، والأمير حيدر الشهابي الذي دوَّن كتاب " تاريخ الأمير حيدر الشهابي المعروف بـ (الغرر الحسان في تواريخ أهل الزمان)"(34).
يتضح مما سبق ذكره، أن الحياة الثقافية والفكرية كانت متطورة في لبنان أكثر مما كانت عليه في فلسطين، بسبب المزيج المذهبي المتنوع فيه، إضافةً لعدم تمكن الدولة العثمانية من فرض قبضتها بالكامل على التراب اللبناني، فالشيعة المتاولة في جبل عامل كانوا في الغالب يتمردون على سلطة الدولة ويستقلون أحياناً عنها، أما الطرف المسيحي فكان يستغل الظروف السياسية التي تمر بها الدولة العثمانية، وغالباً ما كانوا يداهنوها، ويُضاف إلى ذلك أن المسيحيين بخلاف الطوائف السكانية الأخرى تمكنوا من تلقي العلم على أيدي الإرساليات المسيحية التي قدِمت إلى لبنان.
المظاهر الثقافية في عهد الجزار:
لم تستفد فلسطين كثيراً من الناحية الثقافية زمن حكم الجزار، نتيجةً لكثرة الاضطرابات والقلاقل التي سادت معظم فترات حكمه، نتيجةً لفقد عدد من المدارس أهميتها، واتجاه معظم علماء فلسطين إلى مصر ودمشق للتدريس فيهما، أو لينهلوا من فروع المعرفة، غير أن هذا لم يمنع بعضهم من العودة إلى فلسطين لإلقاء الدروس في المسجد الأقصى في القدس(35)، وفي فترةٍ لاحقة تقلصت نسبة العلماء المسافرين للخارج لتلقي العِلم بسبب السياسة التعسفية للجزار في فلسطين من جهةٍ، والحملة الفرنسية على مصر وفلسطين وما ترتب عليها من أزماتٍ اقتصادية من جهةٍ أخرى(36).
غير أن سياسة الجزار هذه لم تمنع بروز أسماء عددٍ من علماء فلسطين خلال فترة حكمه لا نستطيع حصرها هنا، منها: الشيخ محمد بن بدير بن محمد المشهور بابن حبيش القدسي، والشيخ حسين بن محمد الخالدي (1151-1200هـ /1738-1786م)، وهو شيخٌ مقدسي، عالم، أديب، حسن الخط، له نظم على طريقة الفقهاء، درس العلوم الدينية على شيوخ بلده، وأُسندت إليه وظيفتا الشهادة والكتابة في مجلس القضاء في القدس، وصار أحد العدول المرموقين(37)، ومنهم الشيخ محمد أفندي أبو السعود (1148-1228هـ/1735-1813م)، وهو عالمٌ أزهري، مفتي المذهب الشافعي، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الخلوتية والقادرية في الديار القدسية، والشيخ عثمان أبو غوش في منطقة جبل القدس الذي تعهَّد خلال فترة الغزو الفرنسي لفلسطين عام 1799م، بتجنيد خمسمائة محارب لمقاتلة الجيش الفرنسي، وتوفى في أواخر عام 1226هـ (1811م)(38).
ومن أعلام فلسطين كذلك الشيخ محمد أفندي البديري (1160-1220هـ/1747-1805م)، عالمٌ أزهري، وشيخ الطريقة الخلوتية، وأحد أعلام القدس إبان حملة نابليون بونابرت، ومن نظمه قصيدة في هزيمة الفرنسيين عند أسوار عكا تتألف من 157 بيتاً من بحر البسيط مطلعها:
الله أكبر دين الله قـد نصرا وأشرق النصرُ في الأفاق وانتشرا
وكان هذا بفضلِ الله مُنتظرا بنصرِ أحمـد باشا سيد الـوزرا(39)
ويتضح مما سبق بيانه، أن معظم العلماء في فلسطين كانوا من أصلٍ مقدسي، مما يدل على مكانة القدس الدينية كمركزٍ ثقافي اتضحت معالمه خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.
وقد لاحظ البعض(40) كثرة المُفتين في فلسطين في القرن السابع عشر الميلادي/الحادي عشر الهجري واتصالهم واتصال غيرهم من مفتي بلاد الشام والحجاز وبلاد المغرب والدولة العثمانية بكبير المفتين وقتذاك الشيخ خير الدين الرملي للأخذ برأيه، وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على اضطراب العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة لا في فلسطين فحسب ولكن في بلاد الشام والدولة العثمانية ككل.
يتضح مما سبق، أن علماء فلسطين، خاصةً المفتين منهم كانت لهم مكانة بارزة في القرن السابع عشر الميلادي/الحادي عشر الهجري، غير أن هذه المكانة تدهورت كثيراً في القرن الثامن عشر الميلادي/الثاني عشر الهجري، خاصةً في عهد الجزار؛ إذ لم تورد المصادر التاريخية أيّاً من علماء فلسطين ذوي المكانة المرموقة كالتي احتلها الشيخ خير الدين الرملي ـ الذي سبق ذكره.
ورغم سياسة الجزار التعسفيّة واهتمامه بالسياسة على حساب الأوجه الحضارية الأخرى، نجد أن أهم معلم ثقافي قام بإنشائه هو بناء جامع فخم كبير، يُعدّ آيةً في الجمال، ويعتبر من أبدع المظاهر المعمارية في العهد العثماني ببلاد الشام، وأطلق عليه اسمه، فصار يُعرف بجامع أحمد باشا الجزار، ولم يكتفِ الجزار بذلك فألحق بجامعه هذا مدرسة لتدريس العلوم الشرعية والفقهية، كما ضم إليه مكتبة حملت اسم المكتبة الأحمدية ـ نسبةً إلى اسمه ـ حوت أكثر من ثلاثمائة كتاب، كما وُجِد في عكا نهاية القرن الثامن عشر خمسة أو ستة مساجد(41)، قام الجزار بإنشاء نصفها، مما يبيّن عدد سكان المدينة الكبير زمن حكمه(42).
والذي دعا الجزار لبناء هذا المسجد الذي حمل اسمه ومرفقاته، هو ما تمتع به من روحٍ عالية ورغبةً أكيدة في مضاهاة غيره من السلاطين والحكام العثمانيين، فأنشأ مجمعه الخيري هذا على غرار تلك المجمعات العثمانية المنتشرة في تركيا ومصر، أكثر من أي مكانٍ آخر في العالم، فقد انبثقت هذه الرغبة من حب الجزار وشغفه الخاص بالعمارة والبناء سواء كان ذلك في العمارة العسكرية أو المدنية، حتى أنه كان يُشرف بنفسه على وضع المخططات وعلى سير العمل، وهذا ما تؤكده تلك المخلفات المعمارية التي تركها، خاصةً في مدينة عكا، والتي لا يوجد لها مثيلاً في فلسطين وبلاد الشام عامةً(43).
ويبدو أن السبب الذي دعا الجزار لبناء هذا المجمع ومن ضمنه المسجد، هو رغبته في فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل، بعد كل ما اقترفته يداه من ظلمٍ لرعاياه، وقد خصَّ الجزار عمائره هذه بكل أنواع الرعاية حيث أوقف لها الأوقاف لتدر عليها الأموال حتى تبقى محافظةً على بقائها واستمراريتها في أداء رسالتها التي اختطها لها، ويتضح ذلك بأن أوقف عليها الأراضي والبيوت والحمامات والخانات كي تبقي إلى الأبد(44).
ولم يكتفِ الجزار بذلك، فبنى الديوان خانة في قلعة عكا، وعمِل على زرع الحدائق الغنَّاء في عكا لتجميل المدينة(45).
ورغم مظالم الجزار وجوره أثناء فترة حكمه؛ فإن المسجد الذي ابتناه ما زال المؤمنون يؤمونه حتى يومنا هذا، بصرف النظر عن أن عكا اليوم خاضعة لحكمٍ غير عربي أو إسلامي لأسباب قسرية ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي لها، وهذا يُحسب للجزار رغم طول الفترة الزمنية، ومع أن الحكام الذين يوصفون بالقسوة والجبروت كثيراً ما يحاول الناس نسيان ماضيهم وأفعالهم، إلاَّ أن هذا المسجد خلَّدَ اسم الجزار في ذاكرة سكان هذه البلاد.
ومما يدلُّ على أن الجزار كان بنَّاءً عظيماً، أنه بنى سورين لعكا، الواحد ضمن الآخر، وجعل منها أقوى حصن في المنطقة كلها، كما ابتنى الأبراج وأنشأ المباني، وبنى أيضاً سوقاً وحمَّاماً وثكنة عسكرية، وخاناً كبيراً سُميَ "خان المعمدان"(46)، كما أنشأ في عكا خمسة عشر سبيلاً لسد حاجيات السكان من المياه التي كانت تصل من نبع الكابري في قضاء عكا بواسطة قناطر وأقنية مُثبتة فوقها وظاهرة للعيان فوق سطح الأرض(47).
ونظراً لتنوع المذاهب الدينية في المناطق التي خضعت لحكم الجزار المباشر وغير المباشر، فقد كان من الصعب أن تُثمر عن أيَّة نتيجة تخدم الحياة الثقافية، خاصةً في لبنان الذي ذاق الأمرين نتيجةً لسياسات أمرائه، الذين لم يكن لهم من همٍ سِوى الحصول على منصب الإمارة من الجزار بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب مستوى حياة السكان الاقتصادية والثقافية، ناهيك عن دور الجزار في زرع بذور الشقاق بين حكام جبل لبنان لتوطيد سلطته المركزية في عكا، غير أن هذا لم يمنع من ظهور بعض المظاهر الثقافية الخارجية في لبنان بسبب تدخُّل بعض رجال الدين المسيحيين الأوروبيين في شؤون الطائفة المسيحية المارونية، فأدخلوا إلى لبنان بعض الأساليب الثقافية كالمطبعة وغيرها من الأمور التي تخدم الثقافة والعِلم لأمورٍ تخدم أهداف التبشير فيه، خاصةً وأن العلاقات بين الموارنة والجزار كانت على النقيض ويكتنفها التوتُّر، مما سهَّلَ على هذه الإرساليات التبشيرية مهمة عملها في لبنان فيما بعد(48).
ولمَّا كان الجزار يخشى ما يخشاه من اتحاد الكلمة بين سكان لبنان بجميع طوائفه، فقد عمد دوماً لزرع بذور الشقاق بينهم، وأضرم نار الفتنة بين عددٍ من زعمائه، خاصة بين أمير جبل لبنان الأمير يوسف الشهابي وبني صعب المتاولة حكام بلاد بشارة والشقيف، وتمكَّن الشهابيون من تحقيق بعض الانتصارات، مما أدّى إلى عجز المتاولة عن حفظ استقلالهم(49).
وبإمكان أي باحثٍ في تاريخ هذه الفترة بالذات، أن يبيّن العوامل التي أدّت ضعف الحياة الفكرية في لبنان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أن ازدياد نفوذ الجزار وسطوته على أمراء ومشايخ لبنان، إنما يعود في المقام الأول لتخوفهم منه لقوة شخصيته، التي استطاع من خلالها فرض هيبته على لبنان وغيره من مدن الشام وأقاليمه.
أن لبنان أصبح مستكيناً لحكم الجزار، نتيجةً لانشغاله في الصراعات الداخلية، والمنافسة على الوصول للحكم ببذل المزيد من المال للجزار.
أن تفاقم الاضطرابات والفوضى السياسية في جبل لبنان، ترجع في الأساس إلى تهور الأمراء اللبنانيين، ونجاح الجزار في استثمار ذلك الحمق بتأييد أميرٍ ضد آخر للاستفادة مادياً من هذه الخلافات، والذي أتى في سياق الشبق الجزاري للحصول على المال بأية طريقة أو وسيلة(50).
وقد سبق الإشارة، إلى بروز عدد من الكتّاب المسيحيين الذين أسهموا في كتابة تاريخ لبنان ونهضته، ورغم الظلم والقهر الذي أوقعه الجزار على أهالي لبنان، فقد ساهم هؤلاء الكتّاب في عهده مسيرتهم الفكرية، وألفوا العديد من الكتب التاريخية وصبوا جام غضبهم عليه، وبينوا المظالم والمساوئ التي رافقت حكمه للبلاد.
ومن أشهر الكتّاب الذين عاصروا الجزار نجد نقولا الترك الذي دوّن مخطوطاً موجوداً في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بعنوان: "حوادث الزمان في جبل لبنان"، والخوري ميخائيل بريك، الذي دوّن كتاباً بعنوان: "تاريخ الشام" تناول فيه الأحداث التاريخية من سنة 1720-1781م، بلغةٍ ركيكة أقرب إلى العامية، والأمير حيدر الشهابي ـ الذي سبق ذكره، وينتمي إلى الأسرة الشهابية التي حكمت جبل لبنان منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، إضافةً لطنوس الشدياق ـ المار ذكره أيضاً.
وفيما يخص علاقة الجزار بمتاولة جبل عامل، فقد تميزت علاقته بهم في بعض الفترات بالهدوء والتعاون المشترك، غير أن تصادم المصالح بين الطرفين أدّى إلى النفور ووقوع المعارك بينهم، ولكن في المحصلة النهائية لم يختلف موقف الجزار وسياسته تجاههم في جوهرها عن الإطار العام لسياسته في لبنان عامة، ورغم أن المتاولة قاموا بعدة انتفاضات ضد حكمه وسطوته، إلاَّ أنها فشلت جميعاً لافتقارها للتنظيم وعدم وجود القائد الذي يتولاها(51).
ولقد وُجِد في جبل عامل عددٍ من العلماء زمن حكم الجزار، لاقى الكثير منهم العنت والتعسُّف منه، فاضطروا لمغادرة بلادهم خشيةً من عِقابه، ونزلوا إلى الهند والعراق وإيران وأفغانستان حيث قاموا بخدمة المذهب الشيعي الإمامي في تلك البلاد، وكان مِمن فرَّ من العلماء، الشيخ إبراهيم يحيى العاملي الذي سكن دمشق، وألقى فيها قصيدة تناولت الكوارث التي نزلت بجبل عامل زمن الجزار، جاء في مطلعها:
من لي بردِّ مواسم اللذاتِ والعيش بين فتى وبين فتـاةِ
ورجوع أيام مضينَ بعاملٍ بين الجبال الشُمِّ والهضباتِ(52)
وقال في قصيدةٍ أخرى:
ديـار شفـى قلبـي عليـل نسيمها وطابت لديها غدوتي وأصائلي
وما كان هجري "عاملاً" عن قلي لها ولكن نبت بي في رُباه منازلي(53)
وكان الشيخ إبراهيم يحيى العاملي قد أرَّخَ لمقتل الشيخ ناصيف النصار بهذه الأبيات:
قُتِلَ ابـن نصار فيا لله مـن مولى شهيدٍ بالدماءِ مُضرجِ
وتداولتنا بعـده أيـدي العِدىَ من فاجرٍ أو غادرٍ أو أهوجِ
هي دولةٌ عمَّ البلاد الظُلم في تاريخهـا الله خيرُ مُفـرجِ(54)
وممن غادر جبل عامل وكتب شعراً في الحنين إليها، الشيخ سليمان ظاهر الذي قال:
ألا تـربت مـن الجـزار كف بها للفخـرِ كـم ظـهر أجب
وكم غُرِست بأرضِ الشامِ غرساً ألـذ جنـاهُ خـطانِ وخـطب
وكـم دُكـت بعـاملةٍ حصونـاً لها الأسوار بيض ظبي وغلب(55)
وقد وُجدت بعض المدارس في جبل عامل زمن الجزار منها مدرسة الكوثرية شمالي جبل عامل على مقربةٍ من النبطية، التي أسسها الشيخ حسن قُبيسي سنة 1182هـ/1768م، بإيعازٍ من مدينة النجف الأشرف مركز العقيدة الشيعية ذات الصلة الوثيقة بجبل عامل، ومن أبرز من تخرّج من هذه المدرسة السيد علي ابن السيد إبراهيم الحسيني الذي تولى الإفتاء في القسم الشمالي من جبل عامل في عهد ولاية سليمان باشا العادل وعبد الله باشا(56)، اللذين توليا الحكم بعد الجزار مباشرةً.
ويبدو أن الحياة العلمية والفكرية في جبل عامل واجهت العديد من الصعوبات في عهد الجزار، خاصةً السياسية منها، بسبب حروب الجزار في تلك المنطقة سنة 1195هـ/1781م، والتي أدت إلى هزيمةٍ مدوية للمتاولة الذين تزعمهم ناصيف النصَّار ومقتله في معركة يارون، وما ترتب على ذلك من فقدان المتاولة لاستقلالهم السياسي طيلة فترة حكم الجزار، بعدما تمكنت قواته من الاستيلاء على عددٍ كبير من القلاع الحصينة مثل هونين وتبنين إضافةً إلى مدينة صور الساحلية(57)، فانتشرت الفوضى ونشبت الثورة ضد جند الجزار في غير مكان، فأُغلقت المدارس وأُقفلت معاهد العلم وانقطعت سلسلة التدريس بعد أن احتلت منزلة رفيعة ومرموقة وأحرزت شهرة واسعة، وصلت إلى مواطن الشيعة في الهند وإيران وروسيا وغيرها من البلدان التي تواجدوا فيها .
ومما يدلُّ على قلة المظاهر الثقافية في عهد الجزار، ما انتاب بلاد الشام عامةً وفلسطين خاصةً في عهده، من إصابة تلك البلاد بالجفاف وأحياناً بالوباء، كما حدث في عامي 1780 و1787م، فقد قدَّرَ القنصل الفرنسي في عكا(59) إصابات مدينة عكا فقط في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 1786م، و18 نيسان (أبريل) 1787م، بـ 4557 وفاة، بينهم عدد كبير من الجند والأغراب.
ويبدو أن المظاهر الثقافية في مناطق حكم الجزار كانت خارجية أكثر منها داخلية، ففلسطين تأثرت ثقافياً على سبيل المثال في عهد الجزار أكثر من أي منطقة أخرى في بلاد الشام من نتائج الحملة الفرنسية التي لم تتعدَّ حدود فلسطين؛ فنتيجةً لهذه الحملة ورغم فشلها الذريع سياسياً وعسكرياً في تحقيق أيٍّ من طموحات نابليون بونابرت، إلاَّ أنها حققت بعض النتائج الثقافية التي استفادت منها فلسطين بعد مغادرة الحملة لأراضيها، فقد استفادت فلسطين من الحملة الفرنسية علمياً؛ إذ قام علماء الحملة بعملية إحصاء لجميع القبائل العربية الفلسطينية من خان يونس وحتى أقصى الشمال، حيث قدرت عدد سكان فلسطين بنحو 400 ألف نسمة، يعيش 20% منهم في المدن.
كما قام علماء الحملة الفرنسية برسم خريطة للساحل الفلسطيني، أشرف على تنفيذها أحد ضباط الحملة هو الكولونيل "جاكوتين"، ظهرت عليها جميع المدن والقرى التي مرّت بها الحملة أثناء توجهُها نحو عكا سنة 1799م، وتعتبر هذه الخريطة الأولى من نوعِها لفلسطين بالمعنى الكارتوغرافي الحديث، حيث تميّزت بالدقة بدرجةٍ لا تختلف كثيراً عن الخرائط الحديثة.
وكان من نتائج الحملة أيضاً وتأثيرها الآني لا البعيد المدى، أنها تركت وراءها دماراً في البنية التحتية خاصةً في مجال العمران نتيجةً للمعارك التي وقعت في مدنها خاصةً في يافا، كما أنها أسهمت في إفقار الأهالي، بعدما صادر الفرنسيون الجِمال والحمير منهم لاستخدامها في نقل عتادهم، كما كانوا قد صادروا المؤن من المدن والقرى لسد حاجاتهم الحياتية.
كما تأثرت مدينة حيفا سلباً كذلك من الحملة الفرنسية، فبعد ترك الفرنسيين لفلسطين، لم يُعِد العثمانيون المدافع التي كانوا قد نقلوها إلى عكا إلى | |
|